ضمانات حماية الحياة الخاصة في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي
المقدمة
لكل فرد الحق في حماية حياته الخاصة وعدم المساس بها بأي حالٍ من الأحوال، إذ يُعد هذا الحق من الحقوق الأساسية التي كفلتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية، غير أن التطور التقني الهائل في عصرنا الحالي جعل هذا الحق من أكثر الحقوق عرضةً للانتهاك، نتيجة الاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة، التي متى ما أُسيء استخدامها تحولت من أدوات لخدمة الإنسان إلى وسائل تهدد خصوصيته وتنتهك حياته الخاصة.
إذ تتعدد الجرائم التي يتم ارتكابها في البيئة المعلوماتية لتشمل صورًا مختلفة من التعدي على الحياة الخاصة، كالتجسس على البيانات الشخصية أو نشر الصور والمقاطع دون أذن أصحابها، التي تدخل تحت مفهوم الجريمة المعلوماتية التي أتى تعريفها في المادة (1) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بقولها:” أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.”
ويهدف المقال إلى تثقيف الأفراد بحقوقهم القانونية في حال انتهاك حرمتهم الخاصة من خلال الاعتداء على حياتهم الشخصية في البيئة المعلوماتية، كما يهدف بصورة رئيسية إلى تسليط الضوء على الضمانات لحماية الحياة الخاصة في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
المبحث الأول: الحياة الخاصة بين الحق المشروع والمسؤولية النظامية
المطلب الأول: مفهوم الحياة الخاصة في ضوء النظام والفقه
- الخصوصية كحق أصيل مكفول شرعًا ونظامًا.
يُعد الحق في الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالإنسان، والاعتراف به لا يُنشئ هذا الحق وإنما يُعدّ كشفًا عنه وإقرارًا بوجوده الطبيعي، وقد تعددت التعريفات لمفهوم حرمة الحياة الخاصة في الفقه والنظام.
أولاً: تعريف الحياة الخاصة في الفقه
كان الإسلام هو الأسبق إلى إعلان حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية وغيرها، إذ وضع أفضل معيار لحماية الحرمات الخاصة، فحرّم التجسس وتتبع عورات الناس أو معايبهم أو الكشف عن أستارهم، مصونًا بذلك حق الإنسان في خصوصيته وكرامته.
واتجه عدد من الفقهاء، وفي مقدمتهم الفقهاء الأمريكيون، إلى اعتبار أن الحياة الخاصة تقوم على مبدأ العزلة، أي أن للإنسان الحق في أن يعيش بمعزل عن تدخل الآخرين أو نشر معلوماته دون إذنٍ منه. وقد تبنّى الفقهاء الفرنسيون هذا الاتجاه، فعرفوا الحياة الخاصة بأنها:” حق ينطوي على عنصر الذاتية في الإنسان، ويتعلق بشخصه وأمنه وطمأنينته بعيدًا عن تدخل الآخرين.”
ومن جانب آخر، تبنّى فريق من الفقه تعريفًا أوسع لمفهوم الحياة الخاصة من حيث تعدد مظاهرها، باعتبارها مطلبًا للأفراد والجماعات والهيئات، يقوم على حقهم في تقرير مدى إتاحة المعلومات الخاصة عنهم وانتقالها إلى الآخرين.
ثانيًا: التأصيل القانوني للحق في الحرمة الخاصة
وردت في العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان نصوص تُقر بحماية الحياة الخاصة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (17) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جاء فيها:” للحياة الخاصة حرمتها، والمساس بها جريمة، وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات ووسائل الاتصالات الخاصة.”
أما في النظام السعودي، فقد تضمّنت عدة أنظمة نصوصًا تكفل الحق في الخصوصية، وتؤكد على عدم جواز اطلاع الآخرين على ما يعده الشخص شأنًا خاصًا إلا بإذنه، تعزيزًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على صون الكرامة الإنسانية وحماية الحرمات، ونذكر من هذه النصوص الآتي:
- المادة (37) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على:” للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.”
- المادة (40) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على”: المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.”
- المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على:” للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.”
- ضوابط التوازن بين حرية التعبير والحق في الخصوصية.
لا يُعد التعبير عن الرأي في حد ذاته مخالفة، ما دام خاليًا من الإساءة أو التحريض، ولا يصل إلى حد انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، وعليه، فقد وضعت ضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحق في الخصوصية، ونذكرها على النحو الآتي:
- أن يكون التعبير عن الرأي ضمن حدود النظام والآداب العامة، وألا يتضمن ما يمس العقيدة أو يخل بالنظام العام.
- أن يكون التعبير عن الرأي بالشكل المشروع، بحيث لا يكون كوسيلة للنيل من سمعة الآخرين أو المساس بكرامتهم أو حياتهم الخاصة.
- ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين حرية التعبير وحماية الخصوصية، بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى.
- لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، غير أن هذا الحق ليس مطلقًا، ولا يجوز اتخاذه ذريعة للتعدي على خصوصية الآخرين.
- متى يُعد الفعل مساسًا بالحياة الخاصة ومتى يكون مبررًا قانونيًا.
ينص المبدأ العام على أن الأصل في الأفعال الإباحة، ما لم يرد نص شرعي أو نظامي يقيد حرية الشخص أو يضع للفعل ضوابط وحدودًا معينة، ويُعد تجاوز تلك الضوابط مخالفة أو جريمة، ينتقل بها الفعل من كونه مباحًا إلى كونه مساسًا بالحياة الخاصة للأفراد.
ذكرنا فيما سبق، أن للحياة الخاصة حرمتها ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال، إلا إنه يجوز تقييد الحق في الخصوصية متى كان هناك نص نظامي يجيز ذلك، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو إباحة إجراء التفتيش عند حالة التلبس بالجريمة، إذ يشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز الفعل حد الضرورة، أي أن يكون بقدر ما يحقق الهدف النظامي دون تعد.
ولما كانت حرمة الشخص تحمي جسده وملبسه وماله وما معه من أمتعة، فإن لكل شخص الاعتراض بكافة الوسائل على وصول المعلومات التي تتعلق بخصوصيته لدى الغير، فإن ذات الأمر ينطبق على الجرائم المعلوماتية ما إذا وصلت إلى حد المساس بالحياة الخاصة، إذ إنه في المقابل يوجد خصوصية معلوماتية تعنى بأنها: ” ضمان حفظ المعلومات المخزنة في الأنظمة المعلوماتية، أو المنقولة عبر شبكة الإنترنت، وعدم تمكين الاطلاع عليها إلا من طرف الأشخاص المخولين بذلك”.
المطلب الثاني: نطاق الحماية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- نص المادة (3/5) وتفسيرها القضائي.
لما كان التشهير هو إشاعة السوء عن فرد بين الناس بغرض الإساءة إليه والانتقاص منه، فإن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أتى بتجريم مثل هذه الأفعال لما فيها من الكذب والافتراء ونشر الأخبار الكاذبة عن الآخرين.
حيث نصت المادة الثالثة في فقرتها الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من شهر بالآخرين بقصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
ولا تقوم جريمة التشهير إلا بتوافر أركانها النظامية، وهي:
- الركن المادي:
هو الفعل الملموس أو السلوك الظاهر الذي يصدر من الجاني ويُشكل الجريمة، ويتحقق الركن المادي في جريمة التشهير من خلال عندما يقوم شخص بنشر، أو إرسال، أو تداول عبارات، أو صور أو مقاطع تتضمن إساءة أو انتقاص من شخص بما يضر بسمعته أو مكانته.
- الركن المعنوي: هو القصد الجنائي، أي نية الجاني وعلمه بأن فعله يؤدي إلى المساس بخصوصية غيره.
- صور المساس بالحياة الخاصة في الواقع العملي.
تتعدد الصور التي تشكل في جوهرها مساسًا بالحياة الخاصة، إذ إن التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة أوجدت طرقًا مختلفة للاعتداء على خصوصية الأفراد، ومن أبرز هذه الصور ما يلي:
- التصوير:
يُعد التصوير دون إذن من الشخص من أكثر صور المساس بالحياة الخاصة شيوعًا، سواء تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة أو العامة، أو باستخدام الهاتف المحمول أو الكاميرات أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ومن منطلق اعتبار أن الصورة من أهم مظاهر التي يرد عليها الحق في الخصوصية، لقد نصت المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في الفقرة الرابعة، على حظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف أو الكاميرات.
ولأن الأصل في التصوير الإباحة، إلا إنه يبقى مقيدًا بعدة شروط نظامية ما إن تنصل منها الشخص دخل فعله في دائرة التجريم، ولعلنا نطرح مثالاً ليتضح البيان وهو ما إذا صور شخصًا مقطع فيديو لشخص آخر في مكان عام وسخر منه فإن هذا يرتب مسؤولية قانونية ويستلزم عليه تعويض المتضرر، استنادًا لنص المادة (120) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على”: كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه التعويض”.
- التسجيل:
ويقصد به تسجيل المحادثات أو المكالمات دون علم الطرف الآخر، ويُعد هذا السلوك انتهاكًا صريحًا لحق الشخص في سرية اتصاله وحديثه، خصوصًا إذا استُخدم التسجيل في غير الغرض الشخصي أو دون وجود مسوغ نظامي.
إذ للمحادثات والمكالمات حرمتها الخاصة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
- النشر:
ويتحقق هذا الفعل عند نشر أو بث أو مشاركة الصور أو المقاطع أو التسجيلات التي تتعلق بشخص معيّن، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة نشر عامة، بما يترتب عليه كشف أمور خاصة أو الإساءة إلى سمعة الشخص واعتباره الاجتماعي.
- التهديد بالنشر: وتتمثل هذه الصورة في قيام شخص بتهديد آخر بنشر صور أو مقاطع أو تسجيلات خاصة به، بقصد ابتزازه أو إجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وهذه الصورة تُعد جريمة مركبة، تجمع بين المساس بالحياة الخاصة وجريمة الابتزاز، ويعاقب عليها النظام بعقوبات مشددة.
- أمثلة من أحكام النيابة العامة وهيئة الاتصالات.
من بين الأمثلة التي تعد مثالاً للجرائم المعلوماتية وتمثل مساسًا للحياة الخاصة للأفراد، هي عندما قامت النيابة العامة برفع دعوى جزائية ضد أحد الأشخاص بتهمة إساءة استخدام وسائل التقنية، وذلك من خلال قيامه بالتشهير بأحد أقاربه عبر رسائل البريد الإلكتروني.
إذ أرسل المتهم رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وإلى عدد من الأشخاص الآخرين، تضمنت عبارات سبٍّ وشتمٍ وقذفٍ، وهو ما يُعدّ مساسًا بسمعة المجني عليه ومكانته الاجتماعية، وتشهيرًا واضحًا به.
وبناءً على ذلك، نظرت الدائرة الجزائية المختصة بالقضية، وثبت لديها أن ما قام به المتهم يُشكل جريمةً منصوصًا عليها في المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تجرم كل من يستخدم وسائل التقنية للإساءة إلى الغير أو التشهير بهم.
فحكمت الدائرة بإقامة الحد الشرعي عليه فيما يتعلق بألفاظ القذف، ومعاقبته بالحق العام بسجنه مدة شهرين، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال، استنادًا إلى نص المادة المشار إليها، لما تضمنه فعله من تشهير وإساءة صريحة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المبحث الثاني: المسؤولية النظامية وحدود التجريم في ضوء نية الفاعل والقرائن التقنية
المطلب الأول: تمييز الجريمة العمدية عن الفعل غير المقصود
- أثر القصد الجنائي في التكييف النظامي
لا تقوم أي جريمة ما لم تتوافر أركانها النظامية كافة، وهي الركن الشرعي الذي يجرم الفعل، والركن المادي الذي تتحقق به السلوكيات المكونة للجريمة، بالإضافة إلى الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي الذي يعكس نية الجاني واتجاه إرادته نحو ارتكاب الفعل المجرم.
ويُعد القصد الجنائي من العناصر الجوهرية في تحديد التكييف النظامي للفعل، إذ يترتب على توافره أو انتفائه اختلاف في وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها، فالأصل في الأفعال الإباحة، ولا يُصار إلى التجريم إلا إذا ثبت توافر القصد الجنائي بالأدلة أو القرائن المعتبرة نظامًا.
وتطبيقًا لذلك، فإن فعل التعبير عن الرأي مثلاً لا يرقى إلى مرتبة الجريمة إلا إذا ثبت أن المقصود منه الإساءة أو الإضرار بالغير أو المساس بالنظام العام، أي متى توافر القصد الجنائي لدى المتهم وثبت ذلك من خلال ما يقدمه المدعي من أدلة وقرائن تدل عليه.
- مواقف القضاء السعودي من الأفعال العفوية أو غير المقصودة
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والأصل براءة الذمة، وقد استقر قضاء المحاكم على أن الأفعال العفوية أو غير المقصودة لا تُشكل جريمة، ما لم يثبت أن الفاعل تعمد الفعل أو كان على علمٍ بنتيجته الإجرامية.
فمتى كان السلوك ناتجًا عن خطأ غير مقصود أو انفعالٍ لحظي أو مزاحٍ بريء دون نيةٍ للإضرار بالغير، فإن الركن المعنوي ينتفي وبالتالي ينتفي التكييف الجنائي للفعل.
- دور الأدلة الرقمية في إثبات القصد
تعتبر الأدلة الرقمية ذات حجية في الإثبات، ولها ذات الحكم بالإثبات بالكتابة استنادًا للمادة (55) من نظام الإثبات ونصها:” يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام”، وعليه نصت المادة (54) من ذات النظام على ما يعد من قبيل الأدلة الرقمية، الآتية وهي ما وردت على النحو الآتي:
- السجل الرقمي.
- المحرَّر الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
- وسائل الاتصال.
- الوسائط الرقمية.
- أي دليل رقمي آخر.
ويُستفاد من ذلك أن الأدلة الرقمية تُسهم في إثبات القصد الجنائي من خلال ما تحتويه من عبارات أو سلوكيات رقمية تدل على نية الجاني، مثل:
- الرسائل التي تظهر وجود نية سابقة للتشهير أو الإساءة.
- أو المراسلات التي تدل على علم المتهم بنتيجة فعله.
- أو التسجيلات التي تُبين التخطيط المسبق للفعل الإجرامي.
وبذلك أصبحت الأدلة الرقمية من الأدلة التي تدل على اتجاه الإرادة نحو ارتكاب الفعل المجرم، مما يسهم في تحديد التكييف النظامي الصحيح للجريمة.
المطلب الثاني: الضمانات النظامية في صف المتهم
- افتراض البراءة ومبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم.
يعتبر مبدأ افتراض البراءة من أبرز المبادئ التي يعنى الأخذ بها، إذ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا الأصل في الإنسان وليس قرينة بسيطة تقبل إثبات عكسها، بالتالي يفترض أن يعامل المتهم معاملة الشخص البريء في كل مراحل الدعوى الجنائية.
بالإضافة إلى مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم سواء عند مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو عند المحاكمة، وتعد مرحلة جمع الاستدلالات من أهم المراحل سير الدعوى الجنائية إذ على أساسها يبنى الاتهام، وبها تتأثر حقوق المتهم، كونها المرحلة التي يتم فيها جمع الأدلة التي يبني عليها القاضي حكمه، مما يفرض على رجل الضبط الجنائي ألا يوجه اتهامًا للمتهم بمجرد الشك.
- أهمية الخبرة الفنية في تحديد المسؤولية.
تملك الخبرة الفنية دورًا هامًا في تحديد المسؤولية في الجرم المرتكب، وذلك لأن الجرائم المعلوماتية ذات طبيعة خاصة تختلف عن تلك التي تُرتكب في الواقع الفعلي، كونها تُرتكب بوسائل إلكترونية.
ويتعلق إجراء الخبرة بموضوع يتطلب إلمامًا كافيًا من القائم بها، بحيث يتمكن من الوصول إلى الدليل أو تحديد قيمته في الإثبات، فالخبير يُعد مساعدًا للسلطات المختصة في تقدير الأدلة، بحكم المهارة الفنية والمعرفة التقنية التي يمتلكها في مجال محدد.
وتزداد أهمية الخبرة في الجرائم المعلوماتية نظرًا لما تتسم به من تعقيد تقني وتشابك إلكتروني، مما يستوجب وجود خبراء متخصصين يمتلكون الدراية الكافية بالأنظمة المعلوماتية، وأساليب الاختراق، وتقنيات استرجاع البيانات الرقمية، لضمان الوصول إلى الحقيقة بصورة دقيقة وعادلة.
- حق المتهم في عدم تجريم ذاته وحماية بياناته أثناء التحقيق.
للمُتهم ضمانات عديدة في مرحلة التحقيق، لا سيما إذا كان متهَمًا بإحدى الجرائم المعلوماتية التي تتسم بطبيعة خاصة فأنه بجانب حقه في إعلامه عن تهمته ومن ثم توكيل محامي وحضوره، وعدم جواز تقييد تصرفاته أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب النظام استنادًا على ما نصت عليه المادة (36) من النظام الأساسي للحكم:” توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام”.
كما تشمل هذه الضمانات حرمة وسائل الاتصال بجميع صورها، وعدم جواز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا وفقًا لما يقرّره النظام، عملًا بنص المادة (40) من النظام ذاته، والتي تنص على أن:
“المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام”.
ويمتد هذا الحظر ليشمل البيانات والمعلومات الإلكترونية التي تُعد جزءًا من الحياة الخاصة للفرد، فلا يجوز فحصها أو استخراجها أو تداولها إلا في الحدود التي يجيزها النظام، ضمانًا لصون خصوصية المتهم وتحقيق العدالة الإجرائية في الجرائم المعلوماتية.
المبحث الثالث: الحلول الوقائية والتوصيات التوعوية لحماية الخصوصية الرقمية
المطلب الأول: الإجراءات الوقائية للأفراد والمؤثرين
- تجنب التصوير أو التسجيل في الأماكن الخاصة
نصّ المنظم السعودي في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على تجريم التصوير أو التسجيل في الأماكن الخاصة دون إذن أصحابها، باعتباره انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للأفراد، ويُعد من قبيل الأماكن الخاصة التي يشملها هذا التجريم: المنازل، القاعات، الجامعات، والعيادات الطبية، وغيرها من المواقع التي لا تكون متاحة للعامة بطبيعتها أو بطبيعة النشاط القائم فيها.
ويستند هذا التجريم إلى الأساس الشرعي المتمثل في قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27]، مما يؤكد على أهمية احترام خصوصية الأفراد وحرمة مساكنهم، وهو ما تبناه النظام في حماية الحياة الخاصة من أي انتهاك أو تعدٍ عبر الوسائل التقنية، إذ يهدف المنظم من ذلك إلى صون خصوصية الأفراد وحماية سمعتهم من التشهير، وتعزيز مبدأ الأمن المعلوماتي في المجتمع.
- التحقق من الموافقات قبل النشر.
جاء نظام حماية البيانات الشخصية في سبيل تعزيز الحماية للبيانات الشخصية التي تعود للأفراد من أي تعدي عليها من الوصول إليها ونشرها، حيث نص على حقوق صاحب البيانات الشخصية في المادة (4) من النظام بقولها:
“يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:
1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.
- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.
3- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
4- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
5- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.”
مما يفهم من نص المادة الواردة أعلاه، أن للفرد حماية مكفولة لبياناته الشخصية من إحاطته بالمسوغ النظامي خلف جمع بياناته الشخصية، بالإضافة إلى حقه في الحصول عليها أو طلب تصحيحها أو إتلافها لدى جهة التحكم التي ورد تعريفها في نص المادة (1) من ذات النظام بأنها:” أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة”.
وهكذا، أتى نظام حماية البيانات الشخصية بغرض حفظ خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم من المعالجة غير المشروعة أو إساءة استخدامها، وذلك من خلال تنظيم عمليات جمع البيانات الشخصية وحفظها ومعالجتها والإفصاح عنها، بما يكفل صون الحقوق المتعلقة بها.
- معرفة حدود المسؤولية النظامية في منصات التواصل.
تُعد معرفة حدود المسؤولية النظامية في منصات التواصل الاجتماعي أمرًا جوهريًا لضمان الاستخدام الواعي والمتزن لتلك المنصات، إذ إن جهل المستخدمين بالضوابط النظامية قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، وقد نص المنظم السعودي على هذه المسؤولية من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإعلام المرئي والمسموع وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة، التي حددت الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، وضمان بيئة إعلامية آمنة تحترم القيم الدينية والاجتماعية.
المطلب الثاني: دور المؤسسات والجهات المعنية في التوعية
- دور هيئة الاتصالات وهيئة الإعلام في الإرشاد والضبط.
تملك كلتا الهيئتان دورًا هامًا في الإرشاد والضبط إذ تمسك بزمام التنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي، من خلال وضع الأنظمة والسياسات والضوابط التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسسات التي تكفل الوصول لبيئة إعلامية آمنة.
ومن هذا المنطلق، ورد في نظام الإعلام المرئي والمسموع في المادة (5) ضوابطًا للمحتوى الإعلامي بقولها:
يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما يأتي:
1- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.
- عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.
3- عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
4- عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.
5- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.
6- احترام الذات الإنسانية.
7- عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
8- عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي.
9- عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
10- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
11- احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام.
12- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة.
13- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.
14- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
15- عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
16- المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
17- أي ضابط آخر يقره المجلس.
وعلى الجانب الآخر تعنى هيئة الاتصالات بحماية المصلحة العامة وحمية المستخدم ومصالحه ورفع مستوى الثقة لديه، عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية المعلومات كما ورد في المادة (2) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
- التوعية القانونية في الجامعات والمنصات الرقمية.
تمثل الجامعات والمنصات الرقمية بيئة مثالية لنشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع المختلفة، ولا سيما فئة الشباب، من خلال إدراج مبادئ الثقافة النظامية ضمن الأنشطة الأكاديمية والبرامج التوعوية، واستثمار المنصات الرقمية في تبسيط المفاهيم القانونية وإيصالها بطريقة تكفل الوصول إلى بيئة إعلامية آمنة، ما أن نشر الوعي من خلال حسابات هيئة الإعلام في منصات التواصل الاجتماعي يعد وسيلة فعالة للوصول إلى بيئة إعلامية منضبطة, ذلك من خلال بث منشورات توعوية تتضمن الضوابط والمخالفات الإعلامية التي ينبغي على الأفراد بها.
- تعزيز الثقافة النظامية بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات:
لما كانت البيئة الإعلامية تعد المؤثر الأول في تشكيل وعي الأفراد، فإن تعزيز الثقافة النظامية من خلال الإعلام يسهم في الوقاية من المخالفات قبل وقوعها، ويعد أكثر فاعلية من الاقتصار على تطبيق العقوبات بعد ارتكابها، إذ يُنشئ مجتمعًا واعيًا بحقوقه وواجباته، مدركًا لأثر الأنظمة في حماية المصلحة العامة.
الخاتمة
وفي ختام هذا المقال، فإن الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال السَّبَّاقة في إعلاء شأن الحياة الخاصة، إذ أولتها عنايةً خاصة وحرصت على صونها من أي انتهاك أو تعدٍّ بأي صورة كانت، وقد جاءت الأنظمة السعودية متماشية مع هذا النهج، حيث جرّمت الأفعال التي تمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، تأكيدًا على التزام الدولة بمبادئ الشريعة الإسلامية في حماية خصوصية الأفراد وصون كرامتهم.
وقد توصل المقال إلى عددٍ من النتائج، من أبرزها:
1-أن حماية الحياة الخاصة تُعد من المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأصبحت من الحقوق الأساسية التي يكفلها النظام السعودي.
2- أن النظم القانونية الحديثة في المملكة، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية البيانات الشخصية، جاءت لتترجم هذه المبادئ الشرعية إلى قواعد نظامية واضحة وملزمة.
3- أن التوعية القانونية والإعلامية تُعدّ وسيلة فعالة للوقاية من انتهاك الخصوصية، عبر نشر الثقافة النظامية وتوضيح العقوبات المقررة للمخالفين.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن حماية الحياة الخاصة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي قيمة إنسانية وأخلاقية تسعى المملكة العربية السعودية إلى ترسيخها انسجامًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الرقمي، وأن تحقيق هذه الحماية لا يكون بالعقوبة فقط، بل بالرعاية والتوعية أيضًا، من خلال ترسيخ مبادئ الوعي النظامي في المجتمع.
التوصيات:
- تعزيز برامج التثقيف النظامي للمستخدمين.
- تطوير آلية واضحة للصلح أو التسوية في قضايا الخصوصية البسيطة.
- تفعيل مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
- حماية الحياة الخاصة تبدأ من الوعي بحقوقك وحدود أفعالك الرقمية.
قائمة المراجع والمصادر
- نظام الجرائم المعلوماتية، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/3/1428 هـ.
- نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/106 وتاريخ 2/11/1443هـ.
- نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 9/2/ 1443هـ.
- نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/33 وتاريخ 24/3/1439 هـ.
- النظام الأساسي للحكم، الصادر بأمر ملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/ 8/ 1412م.
- نظام الإثبات، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/ 43 وتاريخ 24/5/ 1443هـ.
- نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/ 2 وتاريخ 22/1/1435هـ.
- الكواري، خليفة. (2025م)، “حرمة الحياة الخاصة وصور التعدي الماسة بالكيان المادي والمعنوي بالنسبة للإنسان “دراسة مقارنة”(مصر- قطر- فرنسا)، 45: 2178-2227.
- الشاذلي، فتوح. (2021م). ” جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية”. مكتبة الرشد، الرياض.
- القطاونه، إبراهيم. (2016م). ” الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة”، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، 13(1): 61-88.
- العتيبي، مقبل. (2023)، ” ضمانات حرمة الحياة الخاصة في ظل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي”، مجلة جامعة الملك سعود،2: 405-426.
- القضيبي، خالد. (2022م)، ” ضمانات وحقوق المتهم في مرحلة التحقيق في النظام السعودي- دراسة مقارنة” كجلة جامعة أم درمان الإسلامية، 18(2): 401-425.
- التميمي، عبد الرحمن. (2023م)، “مبدأ الأصل في المتهم البراءة”، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات العليا جامعة المنصورة.

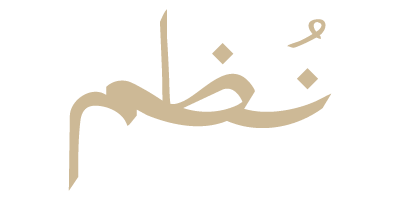

أكتب تعليقا